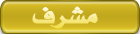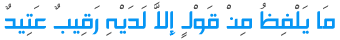السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشــرف المــرسليـن
الحمـد لله وحده نحمده و نشكره و نستعـينه و نستـغفره
اهلا بكم اخوانى اعضاء ومشرفى ومحبى منتديات رأفت الجندى
تفسير قول الله تعالى
﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ.. ﴾قول الله تعالى ذكره ﴿
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 14 - 16].
يقول الله تعالى ذكره: إذا لقي هؤلاء المنافقون الجبناء الخبثاء - المؤمنين أظهروا لهم الموافقة والموالاة والمصافاة، تغريرا ًبهم وخداعاً لهم ومصانعة، وتقية مما يخشونه من السيف وال*** إن ظهروا للمؤمنين على حقيقة حالهم، وإن هم بدوا للمؤمنين بجلية أمرهم من الكفر والخبث، وشدة العداوة للمؤمنين والإيمان. وتقية مما يخشون ويخافون من انقطاع مادة الدنيا التي تصلهم من غنائم الإسلام، وتعود عليهم بفضل الإيمان. فهؤلاء المنافقون حريصون على مجاملة المؤمنين، يجيدون المداهنة، ويتقنون المداجاة والمصانعة ليتخذوا من ذلك ثوبا يسترون به حقيقتهم، ويغطون به شرهم وإفسادهم.
ولقد كان ذلك لقوة الإسلام، وعزة المسلمين وشوكتهم التي كانت بعد غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم فرق الله بين العزة لحزبه المؤمنين؛ والذلة لحزب الشيطان المشركين. يوم فرق الله بين القوة والعلو لكلمة الحق كلمته، والسفال والتلاشي لكلمة الشيطان كلمة الباطل والمبطلين. فكان أولئك المنافقون الجبناء الحرصاء أشد الحرص على الحياة الدنيا ومفاتنها ترتجف قلوبهم وترتعد فرائصهم من الرهبة والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ويحسبون كل صيحة عليهم، وكل حركة تشير إلى عداوتهم، وكل إصبع يشير إليهم: هم العدو. وكلما نزل الوحي ذهبت بهم الظنون كل مذهب أنه سيطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خبيئة نفوسهم ودخيلة أمرهم؛ وحينئذ تكون الطامة الكبرى والصاعقة العظمى على رءوسهم، فما يصدقون أن يفصم الوحي عن رسول الله ويتلو الآيات في الموضوع البعيد عنهم، فترجع الحياة إلى قلوبهم يتنسمون ريحها بعد أن كاد الخوف يقطع نياط قلوبهم، ويذيقها الموت المرير.
وما يكادون يخلصون إلى سادتهم وقادتهم في الكفر والإفساد، حتى يفضوا إليهم بما ساورهم من المخاوف ثم يتظاهرون بالجلد ويقولون ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ بمحمد وصحبه، وإنما نحضر مجالسهم لنغرر بهم ونخدعهم ونهزأ بما يقولون ويعملون.. لننال ما تبتغيه نفوسنا من حياة ومال. حتى يقضي الله بأمره. ونتربص بهم الدوائر. ونرجو أن يجيء الفرج من أي ناحية: من قريش وأحزابها، أو من العرب وجموعها وغضبها لدينها ودين آبائها. أو يموت محمد بهذا أو بغيره فنستريح من هذا العناء، ونعود إلى ما كنا فيه من إظهار ديننا والإعلان بشعائر قومنا. وما زلنا بقلوبنا معكم وبجهودنا نؤيدكم وننصركم، إذا جاء الوقت. وحانت الساعة التي نتربص بهم.
ولقد كان سواد المنافقين وكثرتهم من اليهود - الذين هم أبداً مثال الخبث والمكر وعبادة المادة، وأنموذج الجبن والذلة والصغار والقليل من مشركي العرب من الأوس والخزرج وهم مع هذا لم يكونوا بلؤم اليهود ولا دهائهم ولا خبثهم. فكانت القيادة المعنوية في النفاق لليهود، والإفساد الحقيقي في الإسلام وأهله من اليهود. وهم الذين يتقنون نسج ثوب الرياء جيداً؛ ويجيدون اصطناع المداهنة والمداجاة بما لا يستطيع أحد من الناس أن يجاريهم فيه. على ما تنطوي نفوسهم وصدورهم من الغيظ القاتل. قال تعالى
﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: 119] وقال
﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 76] يصور الله تعالى قبح حال أولئك المنافقين؛ وشناعة ما تخلقوا به من المداجاة والمداهنة ولؤم الطبع وخبث النفس؛ مع الجبن والذلة والصغار. وإنه ليلزم مع المداجاة والمداهنة والمرآة: الجبن والذلة، ولابد. فإنه لو كان عندهم قليل شجاعة. أو شيء من كرامة النفس وعزتها، لصرحوا بما تكن قلوبهم. وليموتوا شجعانًا خير عند العرب من أن يعيشوا أذلة جبناء. وكذلك كل مراء مداهن متصنع للناس بما ليس في نفسه، متجمل عند كل طائفة بما هو عار عنه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم "تجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه".
وقال فيما روى أبو داود وابن حبان"من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار" هذا فيمن يتصنع للناس في أمور الدنيا، فكيف بمن يداهن في الدين، ويداجي في الحق بعد ما تبين بالحجة القاطعة لكل عذر؟ إن شر النفوس وأخسها نفس تسفلت إلى هذا الدرك من الأخلاق الوضيعة؛ وإن هذه الصفات الدنيئة لا تكون مع وازع الإيمان أبداً، ولا تصاحب صدق الإخلاص في حب الله ورسوله، بل هي ملازمة لحب الدنيا، ومصاحبة لمفاتن الدنيا وملاذ حياتها الفانية فكلما فتن الإنسان بهذه الدنيا، واشتد تكالبه عليها، وعظم حرصه على حطامها ومتاعها، وقويت رغبته في مظاهرها ورياساتها: كلما استفاد من أخلاق المنافقين، وبرع في الرياء والمداهنة؛ وأتقن المداجاة والمصانعة، واقتنى لكل مجلس وجها؛ بل ولكل صاحب وجهاً. فلم يكن ذا وجهين فقط، بل كان ذا وجوه متلونة حسب الظروف، ومتعددة مع تعدد الغايات والحاجات.
ولقد كثر هذا الصنف اليوم في الناس - لا كثرهم الله - وأصبحوا وباء عاما وغلب على المجالس والجماعات، حتى لا يكاد يقدر الإنسان أن يميز المخلص من المنافق؛ والصادق من المداهن والمرائي. وغلبت حياة الرياء والنفاق في كل الطبقات: في السياسة، والدين والتجارة والصناعة، وفي كل ناحية، حتى لقد دخلت بين الرجل وزوجه وبين الرجل وبنيه، بل بين الرجل وخادمه. ثم عظم الشر حتى اعتقدوا تلك الخلة المقبوحة المرذولة حسنة طيبة، بل واجبا حسب الظروف ولحسن السياسة والكياسة، وظنوا أنهم في حياتهم هذه سعداء. وهم في الواقع أشقى خلق الله وأبأس الناس بهذه الحياة القذرة بالرياء والمداهنة والنفاق. فاللهم عفواً عفواً. يقول الله تعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حزب الله: لا تغتروا بما يظهره أولئك الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين على الحقيقة: من حلاوة اللسان، وجمال الظاهر، وإظهار الموافقة في الأعمال. فاعرفوهم في لحن القول؛ ودققوا النظر والفكر في سقطات لسانهم، وفلتات أعمالهم؛ تنكشف لكم خباياهم وتنجلي لكم قلوبهم المليئة بالحقد والضغن، وأن نفوسهم الخبيثة لا تقر إلا بالكيد لكم ولدينكم، والعمل على إعادة رياسة شياطينهم، وإظهار كلمة ساداتهم من دعاة الضلال، وقادة الكفر والشرك الذين يصدون عن سبيل الله بما يقيمون من عقبات الوساوس والشبهات والشكوك، وما يلقون في طريق الإسلام من أشواك المعايب والمذام. فهم إذا خلوا إلى هؤلاء نثلوا بين أيديهم ما في قلوبهم؛ ومكنون صدورهم، وقالوا إنا معكم بصادق عزائمنا. وما الذي نعطيه لمحمد وصحبه إلا استهزاء وسخرية لنتقي شرهم، ولندس في وسطهم نشكك الضعفاء منهم، ونزيدهم خبالا ونفتنهم عن دينهم إن استطعنا لعلنا نفرق جمعهم ونفل حدهم، ونوهن قوتهم بما نزلزل من عقائدهم التي صاروا بها إلى هذه العزة والقوة والسلطان، ولكن الله فضح أعمالهم؛ وهتك أستارهم، ورد كيدهم في نحورهم وقوض بنيانهم الذي بنوا، وجعله ريبة في قلوبهم. وقال
﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ فيظهر لهم من عصمة أموالهم ودمائهم في الدنيا، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وعن أعمالهم ما ينخدعون به ويتمادون في غيهم ويزدادون توغلا في عمى بصائرهم وعمههم، وهم لو تأملوا لأيقنوا بما أعد الله لهم من سوء العذاب، وشديد النقمة في الدنيا والآخرة، كما قال
﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾[الأنعام: 110].
والطغيان: شدة العتو في الكفر؛ وشدة التعمق وتجاوز الحد في الضلال والجهل بالله وآياته؛ والعمه: شدة الحيرة والتردد. وهو في القلب كالعمى في البصر.
قال ابن جرير
﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها. فأعمى بصائرهم عن الهدى، وغشاها فلا يبصرون رشدا، ولا يهتدون سبيلا ا هـ.
فهم لا يزالون مفتونين بما خدعتهم به نفوسهم الضالة الجاهلة: من هذا الرياء والنفاق الذي زعموا أنه هو الحكمة والسياسة والكياسة، ولا يزالون متخبطين في حياتهم لا يعرفون لهم مقرا؛ غارقين في بحار جهالاتهم مع شياطينهم لا يعرفون لهم برا، فهم كما قال الله
﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 143] فهم في كل واد يهيمون، وفي كل بيداء تائهون، وفي كل طريق متخبطون. تلك والله حال المنافقين في كل زمان ومكان: أحاطت بهم الحيرة وأخذهم الاضطراب في كل شئونهم وأحوالهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك المنافقون الحائرون المضطربون البعداء
﴿ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ﴾ واشتروا الدنيا بالآخرة، والمتاع الفاني بالنعيم الباقي، والجبن والذلة بالشجاعة والعزة؛ واضطراب القلب وقلق النفس وحيرتها بالاطمئنان وراحة الضمير وهدوء النفس وسكونها إلى فضل الله ورحمته. فأي بيعه خسروا، وأي صفقه أخذوا. ضل سعيهم وخاب أملهم
﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ وما نالوا منها إلا الآلام والشقاء الأبدي، والعذاب النفسي الملازم في الدنيا والقبر والآخرة
﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ إلى طريق المخلص مما أحاط بهم، ولا يستطيعون التخلص من آلامهم وعذابهم، فلعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين نسأل الله العافية، ونعوذ به من شر النفاق والمنافقين، ومن شر تمكن الدنيا وحبها في قلوبنا حتى نقدمها ونقدم العمل لها والسعي إليها على الآخرة؛ فإن من فعل ذلك كان أخسر الخاسرين، وأضل الساعين؛ وأشد الهالكين. ونسأل الله الهداية إلى صراطه المستقيم.
قال العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في حقيقة معنى استهزاء الله بالمنافقين - وما جاء في معناه من الكيد والمكر ونحو ذلك - في كتاب مختصر الصواعق المرسلة:
في كسر الطاغوت الثالث، طاغوت المجاز الذي لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جُنَّة يتترسون بها من سهام الراشقين، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين - وقد ساق في إبطاله خمسين وجها هي من أنفس ما كتب الكاتبون وخير ما ينفع أهل العلم والدين في رد كيد المحرفين لكلام الله عن موضعه. إلى أن قال:
(الوجه الخامس والعشرون) قولكم: نفرق بين الحقيقة والمجاز بتوقف المجاز على المسمى الآخر بخلاف الحقيقة. ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أخذ مدلوليه متوقفاً على استعماله في المدلول الآخر؛ كان بالنسبة إلى مدلوله الذي يتوقف على المدلول الآخر مجازا ، وهذا مثل قوله تعالى ﴿
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانه يتوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق؛ فهو حينئذ مجاز بالنسبة إليه، حقيقة بالنسبة إليهم.
وهذا أيضا من النمط الأول في الفساد، أما (أولا) فإن دعواكم أن إطلاقه على أحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر؛ دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعمال، ومنشأ الغلط فيها أنكم نظرتم إلى قوله تعالى ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾[آل عمران: 54] وقوله ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا ﴾ [النمل: 50] وذهلتم عن قوله تعالى ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ فأين المسمى الآخر؟ وكذلك قوله تعالى ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ فسر بالكيد والمكر. وكذلك قوله ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: 182، 183].
(فان قلتم) يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة كقوله تعالى
﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ وقوله
﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ وقوله
﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ فهذا كله إنما يحسن على وجه المقابلة؛ ولا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى؛ ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفرداً عن مقابله كما يصح أن يقال. يسمع ويرى ويعلم ويقدر.
(فالجواب) أن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين: أحدهما معنوي. والآخر لفظي؛ فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة؛ فلا يجوز اتصاف الرب تعالى بها. وأما اللفظي فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازا. ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعاً. فأما الأمر المعنوي فيقال: لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، ويقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزءا، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها. وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم، والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب؛ فما يذم منها إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا. وهذا هو الذي ذمه الله تعالى لأهله كما قوله تعالى
﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: 9] فإن ذكر هذا عقيب قوله
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8] فكان هذا القول منهم كذباً وظلماً في حق التوحيد والإيمان بالرسول وأتباعه، وكذلك قوله
﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴾ الآية، وقوله
﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ وقوله
﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ [النمل:50، 51] فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة؛ ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتها؛ فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا. والحق خلاف هذا الظن؛ وإنما هي منقسمة إلى محمود ومذموم. فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم؛ حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالمًا متعدياً كان المكر به والاستهزاء به عدلا حسناً، كما فعله الصحابة بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وأبي رافع وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخادعوه حتى كفوا شره وأذاه ، وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله وكذلك ما خدع به نعيم بن مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفوا. وكذلك خداع الحجاج بن علاط لامرأته وأهل مكة حتى أخذ ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحرب خدعة" وجزاء المسيء بمثل إساءته جائز في جميع الملل، مستحسن في جميع العقول.
ولهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر لأخوته ما أبطن خلافه جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه، حيث أظهروا له أمرًا وأبطنوا خلافه، فكان هذا من أعدل الكيد، فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه وادعوا أن الذئب أكله، ففرق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواع، ولم يكن ظالما لهم بذلك الكيد حيث كان مقابلة ومجازاة؛ ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن؛ وإن كانت طريق ذلك مستهجنة، ولكن لما أظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما قذفه به، وكان ذلك سبباً إلى اتصاله بيوسف واختصاصه به؛ لم يكن في ذلك ضرر عليه.
يبقى أن يقال: وقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن على حزنه السابق، فأي مصلحة كانت ليعقوب في ذلك؟.
فيقال: هذا من امتحان الله تعالى له؛ ويوسف إنما فعل ذلك بالوحي؛ والله تعالى لما أراد كرامته كمل له مرتبة المحنة والبلوى ليصبر فينال الدرجة التي لا يصل إليها إلا على حسب الابتلاء. ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبيبيه بعد الفراق، وهذا من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها؛ ومقاساة هذا الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره؛ ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه.
فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق، والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال؛ وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة، وهو أن الماكر المخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له فعله؛ أو ترك ما يجب عليه فعله.
إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة على الإطلاق، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا؛ فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأوْلى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى: المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر المخادع المستهزئ.
ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلقت على نفسه أفعالها في القرآن؛ وهذا لا يقوله مسلم عاقل. والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق. فكيف من الخالق سبحانه. وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه؛ وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا، وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحا فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منها قبيحا البتة فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقرير. وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه، إذ الموجب للمجاز منتف على التقديرين؛ فتأمله فإنه قاطع؛ فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي.
أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله
﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ وقوله ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظًا ومعنى. انتهى.
وقال الراغب الأصبهاني في المفردات:
الهزء: مزح في خفية، وقد يقال لما هو كالمزح - إلى أن قال: والاستهزاء: ارتياد الهزؤ، وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ إلى أن قال: والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصح، كما لا يصح من الله اللهو واللعب. فتعالى الله عنه. وقوله
﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي يجازيهم جزاء الهزؤ. ومعناه: أنه أمهلهم مدة ثم أخذهم مغافصة - أي مفاجأة فسمى إمهاله إياهم استهزاء من حيث أنهم اغتروا به اغترارهم بالهزؤ؛ فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون؛ أو لأنهم استهزأوا فعرف ذلك منهم، فصار كأنه يهزأ بهم، كما قيل: من خدعك وفطنت له ولم تعرّفه فاحترزت منه فقد خدعته. وقد روى: أن المستهزئين في الدنيا يفتح لهم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا انتهوا إليه سد عليهم، فذلك قوله
﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ اهـ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين






 2014-09-20, 03:16
2014-09-20, 03:16